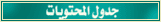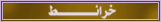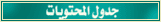|
توحيد الفصائل الجنوبية
واجهت الحركة الشعبية لتحرير السودان في نهاية عام 1994، عدة هزائم أمام قوات الحكومة، التي سيطرت على عدد كبير من المدن والقرى في الجنوب. وقد أدى ذلك إلى انحصار مراكز قيادة الحركة في مواقع قريبة من الحدود مع أوغندا . كما دفع الحركة إلى اتخاذ قرار بتنسيق العلاقات مع مجموعة المنشقين، بزعامة الدكتور "رياك مشار"، الذين شكلوا بدورهم حركة مستقلة باسم "حركة استقلال جنوب السودان". كما فكرت الحركة الشعبية في بلورة علاقة تحالف مع فصائل المعارضة السودانية الأخرى، التي تتمركز في الشمال وتعمل من خارج السودان. . كما دفع الحركة إلى اتخاذ قرار بتنسيق العلاقات مع مجموعة المنشقين، بزعامة الدكتور "رياك مشار"، الذين شكلوا بدورهم حركة مستقلة باسم "حركة استقلال جنوب السودان". كما فكرت الحركة الشعبية في بلورة علاقة تحالف مع فصائل المعارضة السودانية الأخرى، التي تتمركز في الشمال وتعمل من خارج السودان.
بدأت الجبهة الشعبية لتحرير السودان محادثات مع حركة استقلال جنوب السودان، بزعامة "رياك مشار". وتولى "جون قرنق" المحادثات بنفسه. وتم توقيع اتفاق، أُطلق عليه "اتفاق لافون"، تخليداً لذكرى العمل المشـترك، الذي نفّذه ضـباط الحـركـتين في بلدة "لافون" ضد قوات الخرطوم، في 31 مارس 1995.
واشتمل بيان "اتفاق لافون" على الآتي:
- الوقف الدائم لإطلاق النار بين الحركتين، وحرية تحرك قواتهما والسّكان في المناطق، التي يسيطران عليها.
- حرية الحركة لوكالة الإغاثة والعاملين فيها.
- دعوة كل المجموعات الجنوبية المسلحة، إلى الانضمام إلى وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من هذه الخطوة، التي سعت إلى تجميع الجنوبيين تحت قيادة سياسية وعسكرية واحدة، إلاّ أن هناك بعض النقاط، ذات الأهمية الحيوية والتأثير المباشر على احتمالات إتمام المصالحة، التي يبدو أنها لم يُتفق عليها، أو لم تؤخذ في الحسبان بصورة تفصيلية. وهي نقاط قد تثير العديد من المشكلات، وربما تؤدي إلى الانشقاقات، الأمر الذي ينعكس في القدرة على الوقوف أمام هجمات الخرطوم المستمرة، وفقد مساحات واسعة من الأراضي، التي تمت السيطرة عليها في ظل هذا التنسيق، فضلاً عن عوامل أخرى إقليمية. ويُعد من أبرز هذه النقـاط ما يلي : :
- عدم وضوح الرؤية تجاه مستقبل الجنوب السياسي: هل سيتم التمسك بخيار الاستقلال، الذي طرحه "مشار"، أم الوحدة في إطار سودان علماني ديموقراطي فيدرالي، وهو الشعار الذي يرفعه قرنق؟ أم التمسك بخيار تقرير المصير، الذي أخذ يتردد منذ إعلانه في واشنطن عام 1993؟ وقد أثارت هذه النقطة خلافاً بين الجانبين، وعدم حسمها بصورة مفصلة سيؤثر سلباً على شكل العلاقة بينهما وطبيعتها.
- صعوبة حدوث تعاون وتنسيق عسكري ضد قوات الخرطوم في المرحلة الراهنة، لابتعاد تمركز قوات كل حركة عن الأخرى، ووجود قوات حكومية تفصل بين تواصل الحركتين، إضافة إلى بروز عناصر جديدة من القيادات العسكرية لا تقبل التفريط فيما حققته من مكاسب ومواقع عسكرية في الحركتين. فضلاً عن انعدام الثقة المتبادلة بين الجانبين، ومن ثم صعوبة التنسيق الميداني بدرجة عالية، حيث أضحى معروفاً عن قرنق كثرة مناوراته، التي تجعل حلفاءه لا يثقون به كثيراً.
- شيوع الفواصل والتعددية العرقية والأثنية، وكثرة الخلافات حول البنية السياسية والعسكرية داخل القبيلة الواحدة، التي تمثل إحدى السمات البارزة للتركيبة الاجتماعية في جنوب السودان. وكانت أحد الأسباب الرئيسية في انشقاق "رياك مشار" وجماعته، استشعارهم اتساع نقاط السيطرة السياسية لقبيلة "الدينكا" على الحركة. ولذلك فأي تسوية سياسية أو مصالحة أو حتى تنسيق، من الضروري أن يأخذ في الحسبان وضع كل قبيلة ووزنها حتى تتلاشى الهيمنة، التي أوجدها قرنق لقبيلته خلال الفترة الماضية، لتعود من جديد المعادلات والتوازنات القبلية والمناطقية التي تحكم الأوضاع السياسية في جنوب السودان.
- احتمال قيام الخرطوم بشن حملة شاملة على المواقع، التي تتمركز فيها قوات "مشار" في منطقة جنوب شرق بحر الغزال والإقليم الاستوائي، وهي مناطق بعيدة نسبياً عن الأهداف السودانية، لمنع أي محاولة لتوحيد الفصائل الجنوبية تحت قيادة واحدة.
التنسيق بين عناصر المعارضة السودانية
شكلت عناصر المعارضة في الشمال تجمعاً أًطلق عليه اسم "التجمع الوطني الديموقراطي"، يهدف إلى السعي لإحداث تغيير في نظام الحكم في السودان، سواء سلماً عن طريق الدخول في مفاوضات تؤدي إلى إحداث تغيير في طبيعة النظام كلية، أو عن طريق الضغط العسكري، الذي يقود في النهاية إلى إسـقـاط النظام . .
وقد تشكل التجمع في الأيام الأولى لحدوث انقلاب يونيه من عام 1989، ويمثله:
1. من الشمال
الحزب الاتحادي الديموقراطي، وحزب الأمة، والحزب الشيوعي السوداني، والمؤتمر السوداني الأفريقي، والنقابات، وعدد من الاتحادات المهنية، والقيادة الشعبية لقوات الشعب، وقوات التحالف السودانية . .
2. من الجنوب
انضم إلى تنظيمات الشمال في أوائل عام 1990 كل من: الحركة الشعبية، والجيش الشعبي لتحرير السودان، واتحاد الأحزاب الجنوبية . .
ميثاق التجمع
عقد التجمع الوطني اجتماعاً في لندن في فبراير 1992، وأقر ميثاق عمله، الذي اشتمل النقاط الآتية : :
- رفض انقلاب عام 1989، والعمل على مقاومته حتى إسقاطه.
- إنزال العقاب الصارم بكل الذين خططوا له ونفذوه ودعموه، تنظيماً سياسياً وأفراداً.
- وضع برنامج للنضال اليومي، وتحديد مهام المرحلة الانتقالية.
- تصور عام لشكل الحكم في المرحلة الانتقالية، وهو: مجلس سيادة تقتصر صلاحياته على أعمال السيادة، ويتكون من ثلاثة أشخاص يمثلون القوات المسلحة، والنقابات، والأحزاب السياسية، وتكون رئاسته دورية.
- تكوين ممثلين للتجمع الوطني الديموقراطي، يتولى مهام التشريع والسياسة العامة. ويتكون من ممثلين للتجمع الوطني الديموقراطي بأضلاعه الثلاثة، يراعى فيها تمثيل الحركة الشعبية والجيش الشعبي، ومهمته اختيار مجلس السيادة والوزراء.
- يتولى مجلس الوزراء، أعباء السلطة التنفيذية.
- تُشكل في الأقاليم مجالس إقليمية، وأخرى تنفيذية.
كما تم الاتفاق على: صياغة أولية للدستور الانتقالي، ومشروع قانون الأحزاب السياسية، ومشروع للصحافة والمطبوعات، ومشروع يحدد التزامات شاغلي المناصب العليا، وبرنامج اقتصادي للفترة الانتقالية، وبرنامج للسياسة الخارجية والتعاون الإقليمي والدولي.
طرح حق تقرير المصير
طُرح خلال عام 1993 خيار حق تقرير المصير، كأحد الخيارات المتاحة لحل مشكلة جنوب السودان، بعد فشل الحكومة وفصائل الجنوب، في التوصل إلى صيغة إقرار "سودان علمانيّ موحد".
في أكتوبر 1993، عُقدت في واشنطن ندوة تحت اسم "السودان ... المأساة المنسية"، ودعت للمشاركة فيها كلاً من الحكومة السودانية، وجناحي الناصر وتوريت، وبعض عناصر المعارضة. ولكن الحكومة السودانية رفضت الحضور اعتراضاً على اسم الندوة، وعلى مشاركة فصائل سودانية أخرى.
أجرى جناحا الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة "جون قرنق"، و"رياك مشار"، محادثات تحت إشراف وزارة الخارجية الأمريكية، واللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا التابعة للكونجرس الأمريكي. وصدر إعلان في 23 أكتوبر نص على تسوية الخلافات بالطرق السلمية، وعلى تبني مبدأ حق تقرير المصير في جنوب السودان. ونص البيان على الآتي:
- حق تقرير المصير لجنوب السودان، وجبال النوبة، والانقسنا، والمناطق المهمشة الأخرى.
- الوقف الفوري لإطلاق النار، ومراقبة عدم انتهاكه.
- وضع جدول أعمال للسلام والمصالحة والوحدة الوطنية.
- الاعتراف بأن الصراع بين الطرفين، لابد أن يُحل عن طريق وسائل سلمية وديموقراطية.
- تقرير وتشجيع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والمصالحة والوحدة في جنوب السودان، وجبال النوبة، والانقسنا، والمناطق المهمشة الأخرى، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذا الاتفاق.
- الموافقة على تسهيل جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الحرب.
- الاتفاق على معارضة سياسات حكومة الجبهة في الخرطوم، أو أية حكومات مقبلة في الخرطوم، ترفض حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وجبال النوبة، والأنقسنا، والمناطق المهمشة الأخرى.
- اطلاع قادة دول المنطقة على فحوى الاتفاق، في موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر 1993.
مبادرة المنظمة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف "الإيقاد"
بعد فشل مباحثات أبوجا الثانية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1993، ظهر اتجاه قوي لدى دول المنظمة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف، المعروفة باسم "إيقاد"، للتدخل المباشر، بهدف تحقيق معالجة سريعة لقضية الحرب في جنوب السودان، خوفاً من امتداد آثارها السلبية على التوازنات الداخلية لهذه الدول. فكلفت القمة، التي عُقدت في أديس أبابا في 6 سبتمبر 1993، رؤساء دول إثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، وأوغندا، معالجة النزاع السوداني، والعمل على إجراء مفاوضات سلام، وإجراء اتصالات مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى جدول أعمال للمحادثات، ثم المساعدة في التوصل إلى صيغة اتفاق سلمي.
وفي ذلك الوقت تحدد هدف السودان من طرح مشكلة جنوبه أمام "الإيقاد"، في منع فرض عقوبات دولية ضده، والتخفيف من حالة الحصار السياسي والاقتصادي، التي يعانيها على المستوى الدولي، وإبعاد شبح التدخل الدولي، الذي بدا وشيكاً نهاية العام 1993، بعد فشل محادثات أبوجا. فضلاً عن حث دول الإيقاد بعدم تقديم معونات لحركة جون قرنق، أو تبني مواقفها السياسية.
وقد جرت الجولة الأولى من مفاوضات نيروبي تحت إشراف "الإيقاد"، في مارس 1994، وثار خلالها جدل واسع حول الخلافات الرئيسية، مثل طبيعة العلاقة بين الدين والدولة، وشكل العلاقة بين الشمال والجنوب، والهيكل التنظيمي، الذي سيكون عليه الجنوب. وانتهت هذه الجولة دون الاتفاق على شئ، سوى ضرورة الترتيب لجولة مفاوضات أخرى. وقد أظهرت هذه النتيجة مدى التباين في الرؤى، إزاء الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في الجنوب، وإصرار كل طرف على التمسك بمنطلقاته الفكرية. كما تأكد أن وقف إطلاق النار في ذلك الوقت، وبصورة نهائية، كان يلقى اعتراضاً من الحكومة السودانية، التي كانت ترى إعطاء الأولوية للحل الشامل، من منطلق أن وقف إطلاق النار سيأتي حتماً ضمن التسوية العامة للمشكلة.
انعقدت الجولة الثانية في مايو من العام نفسه وانفضت دون مناقشة أي من القضايا الرئيسية. وكانت محصلتها الوحيدة، التوقيع على اتفاقية لتوصيل مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتضررين من الحرب في جنوب السودان. وحدد الاتفاق الطرق والمحطات الواقعة داخل إطار الاتفاق، وفق كثافة السكان وطرق ووسائل توصيل الإغاثة.
عقب انتهاء هذه الجولة، تقدمت دول "الإيقاد" بمشروع إعلان مبادئ، ركزت بنوده على ضرورة الحل بالتفاوض ورفض الحسم العسكري، والأخذ في الاعتبار شمولية تسوية المشكلة، وأسمت المشروع "وثيقة أساس التفاوض". على أن تطرح الآراء للنقاش في الجولة الثالثة. واحتوت "وثيقة أساس التفاوض" على البنـود التالية:
- يتطلب أي حل شامل للمشكلة السودانية، قبول أطراف النزاع والتزامها الموقف القائل بأن تاريخ النزاع السوداني وطبيعته يؤكدان، أن الحل العسكري لن يأتي بسلام واستقرار دائمين للبلاد، وأن الحل السلمي السياسي العادل، يجب أن يكون الهدف المشترك للأطراف.
- ضرورة تأكيد حق أهل جنوب السودان في تحديد مستقبلهم، من خلال استفتاء.
- يجب أن تُعطى جميع الأطراف المتنازعة أولوية للمحافظة على وحدة السودان، شريطة إدخال المبادئ الآتية في صلب التركيبة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد:
أ. السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، والاعتراف الكامل بهذا التعدد واستيعابه أمر يجب تأكيده.
ب. ضمان المساواة السياسية والاجتماعية التامة، بين المواطنين في القانون.
ج. ضمان حقوق الحكم الذاتي على أساس فيدرالي، أو حكم ذاتي لمختلف السودانيين.
د. ضرورة إقامة دولة علمانية وديموقراطية في البلاد، وضمان حرية الاعتقاد والعبادة والدين الكامل لكل المواطنين، مع فصل الدين عن الدولة. وأن تكون مصادر قوانين الأسرة، الدين والأعراف.
هـ. ضرورة القسمة العادلة والمناسبة للثروة بين السودانيين.
و. أن تكون حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، جزء لا يتجزأ من هذه يتضمنها دستور السودان وقوانينه.
ز. أن يضمن الدستور استقلال القضاء.
- في غياب اتفاق على المبادئ الواردة سابقاً، يكون لشعب جنوب السودان الخيار في تقرير مستقبله بعد أجراء استفتاء.
- يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية على إجراءات انتقالية، تشمل تحديد مدة الفترة الانتقالية ومهماتها.
- تتفاوض الأطراف على اتفاق لوقف النار، يسري كجزء من تسوية شاملة للنزاع السوداني.
رأت "الإيقاد" أن إعلان المبادئ في ضوء النقاط السابقة، يمثل ضمانة كافية لوحدة السودان، وقاعدة هامة للتفاوض والوصول إلى حل سلمي يضع حداً للحرب الأهلية. غير أن المفاوضات اللاحقة في الجولة الثالثة التي عقدت في يوليه 1994، وكان مقرراً فيها دراسة بنود "إعلان المبادئ"، فشلت في التوصل إلى صيغة اتفاق حول السلام في جنوب السودان، وقصرت مناقشتها حول موضوعيّ تقرير المصير، والعلاقة بين الدين والدولة.
وفي ختام جولة المفاوضات الرابعة، التي شهدتها نيروبي في سبتمبر 1994، تأكد فشل دول الإيقاد في الوساطة، ورُفض إعلان المبادئ، خاصة من جانب الخرطوم. وبفشل هذه الجهود، بدت مشكلة جنوب السودان على أعتاب الدخول في مرحلة جديدة، سواء من حيث احتمالات التدويل، أو البحث عن وسيط آخر يُحظى بموافقة الحكومة والجنوبيين معاً.
|