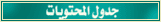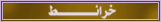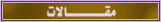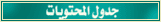|
أركان النظام السياسي في لبنان
1. الميثاق الوطني (7 أكتوبر 1943)
هو ذلك الاتفاق، الذي تم بين بشارة الخوري ورياض الصلح، ويتضمن ثلاثة مبادئ أساسية. أولها، أن يتخلى المسيحيون اللبنانيون عن رغباتهم في طلب الحماية الفرنسية، مقابل تخلي المسلمين عن السـعي إلى ضم لبنان إلى سورية أو إلى أي وحدة عربيـة. وثانيها، يعترف المسيحيون بالفكرة العربية، على أنها تعني مساهمة لبنان في مجال التعاون العربي، في إطار استقلاله وسـيادته، على ألا يطلب من لبنان إتباع سياسة عربية، تتعارض مع مصالحه. وثالثها، اتفاق الطرفين على توزيع مناصب الدولة الرئيسية على الطوائف.
2. الدستور (أول سبتمبر 1926 ـ وتعديله في 21 يناير 1947)
ويتضمن السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية، ولرئيس الوزراء، وكذلك للسلطة التشريعية. وحدد قانون الانتخـاب مدة عضوية مجلس النواب بأربع سنوات. يزاول، خلالها، مهامه التشريعية، والدستورية، والسياسية، والمالية. وفـي الفترة من 1926 ـ 1964، شهدت لبنان 46 وزارة، ومن ثم، يكون متوسط عمر الوزارة أقل من 8 أشهر. ولهذا، لم يكن هناك نوع من استقرار الإدارة داخل لبنان.
3. الأحزاب السياسية
اتسم النظام الحزبي اللبناني بالتعدد، وبالطابع الفردي للأحزاب. وتعد الأحزاب انعكاساً وتعبيراً عن الأوضـاع العشائرية السائدة، إذ مصدر القيادة هو الوضع الأسري، مع عدم وجود حزب أغلبية في مجلس النواب. وفي الوقت عينه، عدم مشاركة الأحزاب السياسية في صنع السياسة. فالأحزاب لا تمارس دوراً رئيسـياً مهماً في العملية السياسية، نتيجة المحددات، التي يفرضها الوضع الطائفي، بالنسبة إلى اختيار النواب، تبعاً لمعايير طائفية.
والواقع أن النظام اللبناني، قام، أصلاً، على توازن ماروني ـ سني، في إطار الأوضاع الطائفية التقليدية السائدة، وأن هذا التوازن، تعرض لعوامل اختلال رئيسية، تمثلت في ثلاثة عناصر، هي : :
- الصعود التاريخي للطائفة الشيعية، منذ نهاية الستينيات، ودخولهم حلبة الحياة السياسـية، تحت قيادة قوية، لها قدر كبير من النفوذ، وهي قيادة الإمام موسى الصدر.
- بروز الحركة الوطنية اللبنانية، والقوى التقدمية، التي رغبت في تأكيد مفهوم المواطنة اللبنانية، على حساب المشاعر والولاءات الطائفية. وارتبط بذلك نمو الأفكار والاتجاهات اليسارية.
- الوجود الفلسطيني في لبنان، والذي كان يقدر بنحو نصف مليون فلسطيني، يسكن ربعهم تقريباً في مخيمات. وفي الفترة التالية لعام 1970، وبعد خروج حركة المقاومة من الأردن، وتمركزهم في لبنان، نشأ موقف، اتسم بازدواج السلطة في لبنان، تمثل في الوجود العسكري المستقل للفلسطينيين، وعدم قدرة الجيش اللبناني على السيطرة عليهم.
وهكذا تشابكت خيوط الموقف اللبناني وتعقدت، واختلطت الاعتبارات الطائفية بالمصالح الطبقية والاجتماعية، وبظروف القضية الفلسطينية وتطوراتها، وبالأوضاع الاقتصادية، بصفة عامة.
من العرض السابق، يتضح أن النظام اللبناني واجه أزمة، لا تتعلق بمشكلة حكم أو تشكيل دستوري، بل بعجز البنية الأساسية السياسية والطبقة الحاكمة، عن التعبير عن القضايا الاجتماعية المطروحة والقوى الجديدة في المجتمع. جوهر الأزمة، إذاً، أن هناك قوى جديدة، ترغب في إصلاح النظام، وتطرح ضرورة إعادة النظر في عدد من أساسياته وفروضه. وفي مواجهة ذلك، يرفض الموارنة تعديل النظام، ويطرح عدد منهم تقسيم لبنان، كحل بديل للمشكلة. ويبدو أن رفض إعادة النظر في الميثاق الوطني أو تعديله، كان خطاً مستمراً لقوى الموارنة الرئيسية. ففي تصريح للرئيس الأسبق سليمان فرنجية، قال: "إن الميثاق الوطني، وهو صيغة للتعايش الأخوي بين اللبنانيين، سيظل كما هو، استجابة لإرادة اللبنانيين، وتطوراً مع أمانيهم، في إطار الاسـتقلال" . ويترتب على ذلك، أنـه لا يمكن إعادة النظر في الميثاق، ولكن يمكن تعديل الدستور. . ويترتب على ذلك، أنـه لا يمكن إعادة النظر في الميثاق، ولكن يمكن تعديل الدستور.
كما طرحت جبهة الأحزاب والقوى التقدمية، برنامجاً شاملاً، يتضمن تعديلات أساسية لنظام الحكم، أسمته "البرنامج الوطني للإصلاح الديموقراطي". وقد صدر في 19 أغسطس 1975، وهو ينطلق من مـبدأ علمانية الدولة، ويطالب بإلغاء الطائفية، وتعديل قانون الانتخاب، وإعادة تنظيم الجيش والأحزاب. كما تضمن الدعوة إلى إلغاء النصوص الطائفية في الدستور والقوانين، على مستوى الممارسة السياسية، للوصول إلى "علمنة" كاملة للنظام السياسي . .
ومن الواضح أن مثل هذه الأزمة، أعمق من أن تكون أزمة أشخاص، أو مؤسسات، بل هي أزمة للنظام السياسي اللبناني، وتتمثل في ثلاثة جوانب هي:
- أزمة عدم التكامل، فالنظام اللبناني، يقاسي الأوضاع الطائفية، والتوازنات الدقيقة بين الطوائف، والتي تكون، عادة، على حساب الكفاءة، أو المصلحة العامة.
- أزمة المشاركة، أي أن النظام السياسي، لا يسمح لكل القوى في لبنان من المشاركة فيه، إن هي رغبت في ذلك. الأمر الذي يجعل حركتـها السياسية، بالضرورة، خارج إطار الشرعية الدستورية، ويجعلها لا ترى في المؤسسات القائمة ما يعبر عن مصالحها أو طموحاتها.
- أزمة توزيع، تتمثل في عدم العدالة في توزيع العائد القومي بين المواطنين، بما يحقق حداً أدنى من الرضاء.
وقد أدّت هذه الأزمات الثلاث إلى "أزمة شرعية"، ويقصد بذلك اهتزاز شرعية النظام السياسي ومؤسساته، في نظر عدد من القوى والجماعات في المجتمع، وإحساسها بضرورة التغيير، والعمل من أجل ذلك.
المناخ الاقتصادي والاجتماعي، الذي كان سائداً في لبنان قبل انفجار الأزمة (1975 ـ 1976)
إن الاتساع الكمي الاقتصادي الكبير، والارتفاع العام للمستويات الاقتصادية، اللذين عرفهما لبنان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم يرافقهما تطور مواز في المضمون الاجتماعي. وكان، من ثم، أن بقيت ثغرة اقتصادية ـ اجتماعية، كبيرة نسبياً، تفصل بين بعض المناطق اللبنانية من ناحية، وبين فئات المجتمع، ضمن كل منطقة على حدة، من ناحية أخرى. وأما محاولة السلطات الحكومية سد هذه الثغرة، فقد كانت محدودة للغاية.
إن التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي، غير المتوازي، عكس إلى درجة كبيرة، تفاوتاً في النمو بين مناطق تسكنها أغلبيات سكانية، كل واحدة منها تنتمي إلى طائفة معينة. وهكذا، أصبح لهذه "اللاموازاة" أبعاداً طائفية، وإن كان من الصعب تحديد أهميتها.
كما إن التضخم المالي، الذي عرفه لبنان في النصف الأول من السبعينيات، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الفترة ما بين عامي 1970 ـ 1974، بنسبة 26 ـ 27 بالمائة  ، أسهم في إبراز الهوة الاجتماعية، التي كانت سائدة وجعلها أشد حدة. ، أسهم في إبراز الهوة الاجتماعية، التي كانت سائدة وجعلها أشد حدة.
هذه الصورة يمكن النظر إليها كإطار عام، يصلح لاستخلاص بعض النتائج، بالنسبة إلى الجوانب الاقتصادية لأزمة 1975 ـ 1976، وهي:
أولاً: نشوء طاقة اجتماعية كامنة، قابلة للانفجار، فيما لو أتيحت لها فرصة التحرك، أو أتيحت فرص استغلالها، على الصعيد السياسي. ومع ظهور التضخم المالي، في أوائل السبعينيات، كبر حجم هذه الطاقة، وأصبحت أكثر قابلية للاستجابة للتحركات السياسية.
ثانياً: أن التقسيم الجغرافي للتفاوت الاقتصادي ـ الاجتماعي اللبناني، إضافة إلى ضعف الأيديولوجية الحزبية الحديثة، أوجد بعداً طائفياً للطاقة اللبنانية الكامنة، والقابلة للانفجار، تخطى المفهوم الطبقي للصراع، أي أن هذا الصراع، إذا ما وجد، بات غير مرتبط، بالضرورة، بعوامل طبيعية صرفة فقط، بل أصبح يتأثر، ولربما إلى حد جد كبير، بالاعتبارات الطائفية والإقليمية.
ثالثاً: مع وجود قابلية الانفجار، الناتجة عن التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي اللامتوازي، فإن هذه القابلية، لم تكن بحد ذاتها، على الأقل حتى السبعينيات، ذات مفعول ضاغط على المجتمع اللبناني، يؤثر تأثيراً كبيراً في مسيرة النمو الاقتصادي ـ الاجتماعي.
ومن ثم، يمكن القول إن العامل الاقتصادي، كان من العوامل المساندة للحرب الأهلية في لبنان (1975 ـ 1976)، بمعنى أنه أتاح للقوة الكامنة إمكانية الانفجار، ولو إلى مدى معين فقط، مع كل أبعاده الطائفية.
إن العامل الاقتصادي ـ الاجتماعي، قد استغل من أجل تغذية حرب، أسبابها الرئيسية سياسية محلية، وخارجية  . وربما جاز القول أن الحرب أتاحت للعامل الاقتصادي ـ الاجتماعي، أن يقوم بدوره، على وجهين: أولهما، يتعلق بالفرصة، التي أتيحت لعناصر لبنانية، لا تنتمي إلى القيادات التقليدية. كما أتاحت الفرصة أيضاً لعناصر غير لبنانية، لكي تتحرك وتحاول أن تجــند طاقات الفـئات، التي عانت التفاوت الاقتصادي ـ الاجتماعي. وثانيهما، يعكس التقسيم الجغرافي، والبعد الطائفي لهـذا التفاوت، الذي استغل في الصراع، القائم على الصعيد السياسي الصرف. . وربما جاز القول أن الحرب أتاحت للعامل الاقتصادي ـ الاجتماعي، أن يقوم بدوره، على وجهين: أولهما، يتعلق بالفرصة، التي أتيحت لعناصر لبنانية، لا تنتمي إلى القيادات التقليدية. كما أتاحت الفرصة أيضاً لعناصر غير لبنانية، لكي تتحرك وتحاول أن تجــند طاقات الفـئات، التي عانت التفاوت الاقتصادي ـ الاجتماعي. وثانيهما، يعكس التقسيم الجغرافي، والبعد الطائفي لهـذا التفاوت، الذي استغل في الصراع، القائم على الصعيد السياسي الصرف.
وبطبيعة الحال انعكست آثار تلك الحـرب، وأثرت، بشكل واضح، في الوضع الاقتصادي اللبناني. فعلى سبيل المثال : :
- الدمار المادي الكبير، الذي لحق بالمنشآت اللبنانية، الصناعية والزراعية والتجارية والإدارية. مما أدى إلى انخفاض الدخل الوطني انخفاضاً كبيراً، وتعطل شبكة التجارة، الداخلية والخارجية. كما أدى إلى نزوح القوى الرأسمالية، والفعاليات الاقتصادية، إلى خارج البلاد.
- تأثير تلك الأحداث في مستوى العمالة، الذي انخفض، بدوره، انخفاضاً كبيراً. وهو ما أدى إلى نزوح عمالي كبير خارج لبنان.
- الخسائر غير المنظورة. ومن أهمها الخسائر البشرية، وزعزعة الثقة بالاقتصاد اللبناني، والإعادة الجبرية لتوزيع الدخل الوطني، نتيجة تدمير المنشآت والسرقات، التي تمت على نطـاق واسع، دون أي رادع. كذلك هناك العديد من التأثيرات السلبية، التي رافقت تلك الحرب، ومنها ازدياد حدة التضخم المالي، والإقفال المؤقت لعدد من المصارف التجارية.
- التأثير السلبي على أجهزة الحكم الرسمية. فانقسمت، بدورها، بل فشلت، في معظمها، وحل محلها، في كثير من المناطق، هيئات محلية، غير رسمية.
بروز المقاومة الفلسطينية، وتفجر التناقضات التقليدية
ما كاد العهد الشهابي ينذر بالأفول، حتى بدأت تظهر، من جديد، وبشكل علني، تناقضات المجتمع اللبناني، مستغلة، هذه المرة، بروز المقاومة الفلسطينية على مسرح الأحداث، بعد حرب يونيه عام 1967. فقد رأى بعض اللبنانيين في المقاومة مدخلاً لهم إلى المسرح السياسي، لإثبات وجودهم، وتحقيق مآربهم. وفي الوقت عينه، حرصت المقاومة، خاصة بعد أحداث الأردن الدامية، على مد يدها، للتعاون مع الفئات الاجتماعية المحلية، إيماناً منها أن هذا التعاون، هو صمام الأمان لحماية نفسها، والعمل على ترسيخ أهدافها في النفوس.
وبسبب التناقض الطائفي والاجتماعي في لبنان، وحرية التحرك، الناتجة عنهما، وجدت المقاومة الفلسطينية أرضاً خصبة، للعمل باستقلال تام عن مؤسسات الدولة وإشرافها. ولكن الواقع اللبناني، والتناقض الطائفي، بالقدر الذي سهلا به دخول المقاومة، وتحركها بشيء من الاستقلالية في العمل، قد جعلاها، في الوقت نفسه، عرضة للاستغلال السياسي، المحلي. وخلال فترة وجيزة من الزمن، في أوائل السبعينيات، أصبحت المقاومة المحور الأساسي، الذي تدور في فلكه مجموعة الرفض اللبنانية، من جماعات مغبونة، وطوائف محرومة، وأحزاب عقائدية سياسية، كانت ممنوعة، حتى الأمس القريب، من ممارسة نشاطها، إلا في الخفاء. والتفت هذه الجماعات والطوائف والأحزاب حول المقاومة، سلباً، لا إيجاباً. جمعتها سياسة الرفض للنظام اللبناني، أو لبعضه. ولم يجمعها، بالضرورة، الإيمان بمبدأ التحرير وأساليبه. فنشأت، من ثم، معادلة واضحة: أنه كلما ازدادت المقاومة الفلسطينية قوة وتماسكاً، ازدادت الهوة عمقاً بين المحاور اللبنانية، الطائفية والاجتماعـية. واستمر هذا الوضع فترة من الزمن، فقدت الدولة، خلاله، سلطانها وسيطرتها . .
|