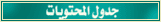




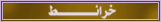 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
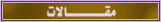 | ||||||||
|
|
الحرب الأهلية (1975 ـ 1976) كانت الحالة الاجتماعية في لبنان، عند مطلع عام 1975: المقاومة الفلسطينية محور التفاف الرفض اللبناني، والدولة اللبنانية محور التفاف مؤيدي صيغة التعايش بين الطوائف، ومعادلاتها الآنية. وقد خيل إلى الكثيرين، قبل الاصطدامات المسلحة، أنه من الممكن التوفيق بين منطق الثورة المسلحة ومنطق الدولة. وكانت نتيجة هذا التخيل اتفاقية القاهرة، عام 1969، والملاحق العديدة التي تبعتها، . وحتى عام 1975، كان كل فريق قابضاً على سلاحه، يريد حماية مصالحه السياسية، بالقدر الذي تكسبه هذه الحماية حق ممارسة شرائعه الدينية، وغير الدينية. وأصبح نظام الحكم وسيطاً بين المحاور المتناقضة، يقرب وجهات النظر، قدر الإمكان. وعندما تبرز متناقضات المجتمع، أي مجتمع، على هذا النحو، تصبح الحادثة، أي حادثة، مؤامرة يحيكها فريق ضد آخر. هذا بغض النظر عن هوية الفاعل الحقيقي، وأهدافه الوطنية. وهكذا اغتيل معروف سعد، نائب صـيدا، ووقعت مجزرة عين الرمانة، التي ذهب ضحيتها أكثر من عشرين شخصاً، في 13 أبريل 1975. فكان هذان الحادثان مدخلاً إلى الحرب. إذ اخذ كل محور يدعي لنفسه البراءة، ويكيل التهم للفريق الآخر. وما يهمنا من هذين الحادثين، هو أنهما كانا الشرارة، التي أدت إلى حرب مسلحة، دامت حوالي سنتين. وهي حرب، ككل حرب، بدأت بهدف ما، وانتهت بهدف آخر مغاير تماماً. والواقع أن الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1976) قد مرت بأربع مراحل المرحلة الأولى: وتركزت على التباينات الاجتماعية (أبريل 1975 ـ أكتوبر 1975): جرت المرحلة الأولى من الحرب، التناقضات الطبقية، الكامنة في المجتمع اللبناني، والتي أصبحت أكثر بروزاً، بفعل النمو الاقتصادي والعمران. إن للإنماء وجهين: وجه يعالج النمو والتقدم بشكل مطلق، كأن يقال، مثلاً، إن الإنتاج، الصناعي والزراعي، أو حملة الشهادات، الجامعية والمهنية، كالطب والهندسة، قد ازدادوا من خمسة بالمائة إلى عشرة بالمائة. ووجه آخر، لا يهتم بالزيادات المطلقة، بل بنسبة توزيعها بين المناطق والفئات المختلفة في المجتمع. ويعبر عن المفهوم الثاني للإنماء بمصطلح: "التنمية الاجتماعية"، أو "العدالة الاجتماعية". وهكذا، يصبح الإنماء طريقة للتكامل بين الفئات المختلفة، قصد التقريب بينها، أي بين الجماهير والنخبة، الأصول والفروع، أو بين الأغنياء والفقراء. ومن الواضح أن التقدم الصناعي والزراعي، وتطوير مرافق الاقتصاد برمتها، إن لم يرافقهما تشريعات جديدة، تقرب بين الفئات، وتجمع بين الشتات، سيؤديان حتماً، إلى تعميق الفروقات، وتقوية المتناقضات، التقليدية والمستحدثة. ومما لا شك فيه، أن لبنان عام 1975، كان أكثر غنى من لبنان قبل ذلك التاريخ. كان أكثر إنتاجاً وحركة مالية وتجارية. ولكنه كان، في الوقت نفسه، أشد وأبرز تناقضاً بين الفقر والغنى، الجهل والعلم، التعقل والتعاطف. وهكذا، ما كادت شرارة الحرب تندلع، حتى انبرى عدد كبير من التنظيمات الشعبية، من أحزاب عقائدية أو مجموعات طائفية، للدفاع عن حقوق المحرومين، مركزة بذلك على الحزام الصناعي، حزام البؤس والفقر، حزام النازحين من القرى إلى المدن، الذي يلف بيروت من الشرق والجنوب والغرب، ماراً ببعض المخيمات الفلسطينية. وقد خيل إلى الكثيرين، آنذاك، أن الأحداث، التي سبقت صيف 1975، ما هي سوى انتفاضة اجتماعية، هدفها الإصلاح، ورأب الصدع بين الفئات المرحلة الثانية: وتركزت حول المتناقضات الطائفية (الربع الأخير من عام 1975 ـ مارس 1976): بينما كان بعض اللبنانيين، يُعدّ لسياسة إنمائية، أكثر عدالة مما سبق، إذ بهجوم مسلح، تشنه مجموعة العشائر السنية في جرود عكار، بالتعاون مع بعض المنظمات، المحسوبة على المقاومة الفلسطينية، ضد بعض القرى المسيحية في تلك المنطقة. وكان قد سبق هذا الهجوم اشتباكات متقطعة، في طرابلس، بين الثائرين الطرابلسيين والنازحين الموارنة، من سكان بلدة زغرتا والجرد. وكان بين الفريقين عداوة تقليدية، يرجع أصلها إلى زمن بعيد. إن الهجوم، الذي شنته العشائر السنية، على القرى المسيحية، في عكار، بدَّل المقاييس، وغير الحسـابات. ذلك أن القرى، التي هوجمت، ريفية، سكانها من الفلاحين والكادحين. وبالفعل، سقط نتيجة هذا الهجـوم عدد كبير من القتلى، حملة السلاح، الذين كانوا ينتمون إلى أحزاب عقائدية، رافضة للحكم اللبناني ومبادئه. ومنذ ذلك التاريخ، في أواسط خريف عام 1975، بدأ الصراع ينحو منحى طائفياً بارزاً. فقد رأت القوى المناهضة لمجموعة الرفـض اللبناني، أن تثأر لقرى عكار من بيروت وضواحيها، وذلك بسبب قدرة مقاتلي القوة المناهضة على الكر والفر في هذه المنطقة، وكذلك بسبب انتماء عدد كبير من نازحي عكار، خاصة الموارنة منهم، إلى حزبي "الكتائب اللبنانية" و"الوطنيين الأحـرار". وكان هؤلاء قد نزحوا من الشمال إلى بيروت والجبل، خلال العقدين السابقين للأحداث. كما انخرط قسم كبير منهم في الجيش اللبناني السابق. استمرت المعارك الطائفية، على عدة محاور في بيروت. وكانت حصيلتها النزوح الطائفي، المتبادل بين المنطقتين، الشرقية والغربية، اللتين يفصل بينهما "خط الشام" الحديدي القديم، الذي فصل، في السابق، بين المتصرفية وخلال هذه المرحلة، التي استمرت حتى إعلان الانقلاب العسكري، في مارس1976، على يد العقيد الأحدب |


