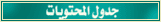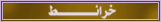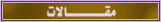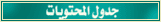|
المرحلة الثالثة: انقسام الجيش اللبناني، وبروز دور المقاومة الفلسطينية (مارس 1976 ـ أغسطس 1976):
احتدم الصراع في هذه المرحلة، أكثر منه في أي وقت مضى. ودخل حلبة الصراع عناصر جديدة، لم يكن لها دور بارز في القتال من قبل. أهم هذه العناصر الجيش اللبناني، الذي انقسم على نفسه، رسمياً، إثر انقلاب الأحدب، وأخذ كل فريق يقاتل إلى جانب طائفته ومحورها. إن انقسام الجيش على ذاته، وضرب مركز رئاسة الجمهورية، التي أصبحت، هي الأخرى، فريقاً من النزاع، أفقدا الدولة كثيراً من صفاتها الشرعية وهيبتها. وعلى الرغم من ذلك، بقي البرلمان مصدر التشريع والشـرعية، مما أكسب الدولة قوة على الاستمرار، على الرغم من تفكك مؤسساتها، بما فيها الرئاسـة . .
بعد انقسام الجيش، وضرب رئاسة الجمهورية، صار العالم يتوقع انتصار فريق على فريق، بطريقة أو بأخرى. وهنا، بدأت تبرز إلى السطح تناقضات المجتمع اللبناني والمقاومة الفلسطينية، في آن واحد، معاً. كان كلما احتدم القتال المسلح، برز إلى مسرح الأحداث قوتان متضادتان: المقاومة الفلسطينية، بفصائلها المختلفة، و"الكتائب اللبنانية" ومن ينضوي تحت لوائها. ولعل السبب في ذلك، اعتماد هذين المحـورين على تنظيمات شبه عسكرية، وعلى نوع من العضوية المتحركة، الفاعلة، في صفوف النازحين الفلسطينيين واللبنانيين. فقد استطاع هذان التنظيمان تحريك قواتهما العسكرية من مكان إلى آخر، حسب ما تفرضه استراتيجية القتال، خلافاً لِمَا كانت عليه التنظيمات الأخرى، التي لم تكن لها القدرة على التحرك. كانت تقاتل، شرط أن يكون القتال محصـوراً في حي أو قرية أو ضاحية معينة، حيث تتمركز هذه التنظيمات.
وهكذا، وبفعل منطق القتال، أخذت فصائل المقاومة الفلسطينية، تبرز إلى مسرح الأحداث بشكل أقوى، وأعنف من قبل، خصوصاً عندما انتقل القتال إلى حدود جبال لبنان الشرقية، مما فرض على المقاتلين رقابة دقيقة وإشرافاً مباشراً. وتجدر الإشارة إلى أن فترة القتال المسلح الطويل، دفعت عدداً من اللبنانيين والفلسطينيين، إلى حمل السلاح، لأغراض متنوعة، فمنهم من قاتل لتحقيق مبدأ ثوري، أو دفاعاً عن النفس، أو لكسب لقمة العيش. ومنهم من حمل السلاح، قصد الابتزاز والتعدي على الآمنين. وكلما أمعن القوم في حمل السلاح، ضعفت الرقابة النظـامية على المقاتلين. فانتشار السلاح أفقد القتال معناه ومضمونه الثوري، وبات الكل يخشى العودة إلى شريعة الغاب، إلا الأحزاب العقائدية، اليسارية واليمينية، التي كانت تمارس الضبط والنظام على أعضائها، والتي لم يكن لها ذلك الوجود المكثف، لفرض نفسها على مجرى الأحداث. كان يخيل إلى المراقب أن القتال مستمر بعد تفتيت الدولة اللبنانية، لمجرد الاقتتال، وليس لتحقيق أهداف سياسية واضحة. وبتعبير أدق، أنه بعد انقسام الجيش، وضـرب رئاسة الجمهورية، وسيطرة القوى على قسم كبير من البلاد ، كان من المنطقي، أن يمارس الثائرون، أياً كانت هويتهم، السلطة، وأن يستأثروا بالحكم. ولكن هذا لم يحدث، بسبب التركيبة الاجتماعية لدى الثائرين. ، كان من المنطقي، أن يمارس الثائرون، أياً كانت هويتهم، السلطة، وأن يستأثروا بالحكم. ولكن هذا لم يحدث، بسبب التركيبة الاجتماعية لدى الثائرين.
كان الثائرون فرقاء عديدين، جمعهم رفض صيغة الحكم في لبنان ومعادلاته. ولم يكن لهم برنامج سياسي موحد يجمعهم في تنظيم واحد. كان بينهم العقائدي اليساري الثائر، والمتدين القلق على مصيره، والمعتدل الذي يريد حماية مصالحه، والتنظيمات والتشكيلات المحلية المتنوعة، التي لم يكن لها لون سياسي معين، انخرطت في صفوف الثائرين لأسباب معيشية وأمنية. فمن لم ينتم إلى تنظيم معين أضاع فرصة الحصول على المؤن المعيشية، كما أنه أصبح عرضة للابتزاز. وما يقال عن مجموع الثائرين على التركيبة السياسية اللبنانية، يقال أيضاً عن المجموعة الأخرى، مع فارق أساسي في البيئة الاجتماعية. كان الفريق، الذي وقف في وجه الثائرين، متجانساً دينياً، وإلى حد كبير، سياسياً، بذلك استطاع، ولو إعلامياً، أن يقف وقفة الرجل الواحد.
ومن المعتقد أنه لو استمر القتال، على نحو ما كان عليه خلال تلك المرحلة، لبرزت، حتماً، إلى مصاف القيادات، ودون منازع، تنظيمات المقاومة الفلسطينية في صفوف الثائرين، و"الكتائب اللبنانية" في صفوف اليمينيين . وبسبب دقة تنظيم هذه العناصر، استطاعت أن تضبط مسلك الأفراد، المنتمين إليها. الأمر الذي أكسبها قوة ونفوذاً بين المواطنين. فلو استمرت الحرب لانضوت تحت ألوية هذين الطرفين، فصائل المجتمع كلها. ذلك أن من يرفض الانضواء، يفقد الحمـاية، وربما العمل وسـبل العيش. . وبسبب دقة تنظيم هذه العناصر، استطاعت أن تضبط مسلك الأفراد، المنتمين إليها. الأمر الذي أكسبها قوة ونفوذاً بين المواطنين. فلو استمرت الحرب لانضوت تحت ألوية هذين الطرفين، فصائل المجتمع كلها. ذلك أن من يرفض الانضواء، يفقد الحمـاية، وربما العمل وسـبل العيش.
المرحلة الرابعة: دخول القوات العربية إلى لبنان، في خريف 1976
وضعت قوات الردع العربية حداً فاصلاً للاقتتال الدامي، ولكنها لم تبدد الحقد والخوف المتبادلين، اللذين ولدتهما الأحداث، وغرستهما في النفوس. وبدأت مرحلة التصفيات المتبادلة. وبدا كأن التجانس الطائفي، الذي تميز به المجتمع اللبناني، في العمل والمسكن، أخذ ينحـسر رويداً رويداً. وبدأ عدد من المسيحيين، الذين كانوا يسكنون ويعملون في المناطق الإسلامية، في تصفية وجودهم في هذه المناطق. وهذا، بالطبع، أضعف البنية القومية، والتماسك الوطني، وقوى التناقضات الاجتماعية في المجتمع الواحد.
فالحرب، التي شنت على الصيغة الطائفية، نجحت في هدفها، ولكنها ـ في المقابل ـ فشلت في إقامة نظام بديل أفضل منها. ولعل الحرب، لو ركزت على التناقضات الجديدة والمستحدثة، بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي ألمت بهذا البلد، لجاءت النتيجة أكثر نظاماً، وأكثر ديموقراطية وتقدماً، متوافقة مع متطلبات الحياة المعاصرة  . .
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1976)
لِمَ لَمْ يفكر الأمريكيون في التدخل العسكري المباشر، على الرغم من أن الموقف بدا أشد خطراً، مما كان عليه عام 1958؟
هناك تفسيرات مختلفة، لتعليل هذا الموقف الأمريكي. ففي عام 1958، كان الدافع الأقوى نحو التدخل العسكري، هو وجود قوة استقطاب نحو الوحدة العربية، ممثلة في تضخيم شخصية الرئيس المصري، جمال عبدالناصر. وهذا العنصر، بات غير موجود في عام 1975. ثم أن الصراع الداخلي في لبنان، صار وثيق الصلة بحركة التحرير الفلسطينية. وفي هذه الحالة، فإن انهيار الدولة اللبنانية أمام الجبهة الفلسطينية ـ الإسلامية، سيؤدي، حتماً، إلى تدخل إسرائيلي. ولم تخف الحكومة الإسرائيلية نياتها، بالفعل، فهددت بشن عمل عسكري، في حالة تدخل طرف خارجي لمصلحة هذه الجبهة. ولعلها كانت تعني سورية على وجه الخصوص. وكأن إسرائيل صارت تؤدي الدور عينه، الذي أدته الولايات المتحدة الأمريكية عام 1958.
ومن بين المتغيرات العالمية، التي صرفت الولايات المتحدة الأمريكية عن فكرة التدخل العسكري المباشر، هو هدوء الحرب الباردة. ففي عام 1958، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً إلى مبدأ أيزنهاور، لمكافحة الشيوعية. أمّا في عام 1975، فقد صار الرأي العام الأمريكي معادياً للتدخل العسكري المباشر بصفة عامة، نتيجة التجربة المريرة في فيتنام. وفي الوقت الذي احتدمت فيه الحرب الأهلية اللبنانية، كان الشيوعيون يقتربون من الاستيلاء على السلطة في أنجولا. وقـد رفض الكونجرس الأمريكي خطة التدخل العسكري هناك. فمن باب أولى، كان لابد أن يرفض تدخلاً في لبنان. وقد ألمحت وزارة الخارجية الأمريكية إلى مضمون سياستها الجديدة، بإصدار بيان يعلن أن لبنان من أوثق أصدقاء واشنطن بالمنطقة. وقد أبلغ كل من سورية وإسرائيل وأطراف أخرى، بهذه الحقيقة. "إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتدخل. وفي الوقت نفسه، لا تسمح بتدخل أطراف أخرى، تهدد الكيان اللبناني" . .
إن إحجام الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل المباشر، لا يعني أن الصراع اللبناني، دار بمنأى عن المؤثرات الخارجـية. فعلـى الأقل، كان لمعظم المنظمات العسكرية في لبنان أعوان في الخارج، يمدونها بالمال والسلاح  . كذلك، اجتذب الصراع اللبناني اهـتماماً خاصاً من بعض الدول، فالفاتيكان ـ مثلاُ ـ أبدى قلقاً شديداً، إزاء تصاعد القتال، وتكاثر الضحايا، وتحرج موقف الموارنة في الصراع. كما أعلنت فرنسا عن استعدادها لتقديم وساطتها، فضلاً عن إعلانها، على لسان رئيسها، في مايو 1976، استعدادها لإرسال 5000 جندي، بقصد الفصل بين الأطراف المتنازعة، وإقرار السلام. ولكن قوبل ذلك العرض باستنكار شديد، من اليسار، ومنظمة التحرير الفلسطينية. ووصفه رشيد كرامي بأنه عودة إلى عهد الانتداب. كما انتقده أيضاً معظم الدول العربية، في حين أيدت "الكتائب" وكميل شمعون هذه الخطة. ولكن، عندما تم التدخل السوري، صراحة، ضد اليسار، أعلن جنبلاط عن تأييد التدخل الفرنسي، للمحافظة على كيان لبنان، ضد فكرة التقسيم، التي أيدتها بعض الأوساط اللبنانية. . كذلك، اجتذب الصراع اللبناني اهـتماماً خاصاً من بعض الدول، فالفاتيكان ـ مثلاُ ـ أبدى قلقاً شديداً، إزاء تصاعد القتال، وتكاثر الضحايا، وتحرج موقف الموارنة في الصراع. كما أعلنت فرنسا عن استعدادها لتقديم وساطتها، فضلاً عن إعلانها، على لسان رئيسها، في مايو 1976، استعدادها لإرسال 5000 جندي، بقصد الفصل بين الأطراف المتنازعة، وإقرار السلام. ولكن قوبل ذلك العرض باستنكار شديد، من اليسار، ومنظمة التحرير الفلسطينية. ووصفه رشيد كرامي بأنه عودة إلى عهد الانتداب. كما انتقده أيضاً معظم الدول العربية، في حين أيدت "الكتائب" وكميل شمعون هذه الخطة. ولكن، عندما تم التدخل السوري، صراحة، ضد اليسار، أعلن جنبلاط عن تأييد التدخل الفرنسي، للمحافظة على كيان لبنان، ضد فكرة التقسيم، التي أيدتها بعض الأوساط اللبنانية.
والواقع أنه لم يكن في وسع فرنسا، أن تغضب الدول العربية، بالانحياز إلى الموارنـة. كما لا يمكنها التدخل ضدهم، لأسباب تاريخية. ومن ثم، بقي العرض الفرنسي حبراً على ورق. وأدرك الموارنة أن عهد التدخل الأوروبي ـ الأمريكي لحمايتهم، قد انتهى. ولذلك، عاد الحديث يتردد عن تقسيم لبنان إلى دويلات، حسب الطوائف. فيخصص للمسيحيين الجبل. وتقام دويلة في الجنوب، يعيش في ظلها الفلسطينيون إلى جانب الشيعة. ويضم الساحل الشمالي إلى سورية. أمّا بيروت، فتعلن مدينة مفتوحة، تتمتع بنظام خاص، يضمن حيادها . وإذا صح ما قيل من أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الأوساط اللبنانية، أيدت هذا المشروع، فإن الهدف منه يكون هو تخليص لبنان من الوجود الفلسطيني، من جهة، وإيجاد دويلة فلسطينية، تُغني عن مطالبة العرب بالضفة الغربية، التي تتمسك بها إسرائيل. ومهما يكن من أمر جدية هذه المقترحات، أو عدمها، فقد قوبلت، بادئ الأمر، بالاستنكار من جميع الأطراف اللبنانية. ولكن، حينما ضاق الخناق على اليمينيين، خلال مارس1976، بادر كميل شمعون إلى الإعلان: "أنه لم يكن يرغب في تقسيم لبنان، لكن التقسيم صار أمراً واقعياً. ومن الجائز قيام اتحاد فيدرالي بين الأقاليم التي انقسمت إليها البلاد" . وإذا صح ما قيل من أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الأوساط اللبنانية، أيدت هذا المشروع، فإن الهدف منه يكون هو تخليص لبنان من الوجود الفلسطيني، من جهة، وإيجاد دويلة فلسطينية، تُغني عن مطالبة العرب بالضفة الغربية، التي تتمسك بها إسرائيل. ومهما يكن من أمر جدية هذه المقترحات، أو عدمها، فقد قوبلت، بادئ الأمر، بالاستنكار من جميع الأطراف اللبنانية. ولكن، حينما ضاق الخناق على اليمينيين، خلال مارس1976، بادر كميل شمعون إلى الإعلان: "أنه لم يكن يرغب في تقسيم لبنان، لكن التقسيم صار أمراً واقعياً. ومن الجائز قيام اتحاد فيدرالي بين الأقاليم التي انقسمت إليها البلاد" . .
|