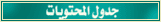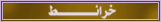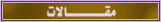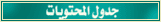|
اتساع القتال، والتدخل السوري
لا شك أن ما بدا من احتمالات التقسيم، لو تحقق، فإن سورية تكون أكثر الدول المجاورة تأثراً بالنتائج المترتبة عليه. فوجود دويلة فلسطينية، أو شيعية في الجنوب، متاخمة لإسرائيل، يتيح للأخيرة استغلال الفرصة لابتلاع تلك الدويلة. ويشكل ذلك عامل ضغط جديداً على الجبهة السورية. ولما اتسع نطاق القتال، خلال شهري ديسمبر 1975 ويناير 1976، تبين أن الهوة قد اتسعت بين الأطراف المتنازعة، حتى صار من المتعذر، أن تسوي وحدها منازعاتها، دون وساطة طرف خارجي. وهكذا، جاء التدخل السوري على شكل وساطة للتوفيق. وما لبثت الوساطة السورية، أن امتدت إلى المجال السـياسي. كما أن مشاركة الفلسطينيين، صارت ضرورية، بعد أن تورطوا، إلى حد كبير، في النزاع الداخلي اللبناني. فتشكلت لجنة ثلاثية، مثلت فيها سورية ومنظمة التحرير، ورأسها مندوب عن لبنان، ومهمتها ترتيب وقف إطلاق النار، والسهر على تنفيذه. ثم امتدت الوساطـة السورية إلى قضايا المجتمـع والسياسـة اللبنانيين، مثل إعادة النظر في التركيب الطائفي للدولة.
وكان جميع الفرقاء قد وافقوا على مبدأ التغيير، وبقي الخلاف قائماً حول كيفية تحقيقه. وبعد تكوين لجنة للإصلاح، مثلت مختلف الطوائف في لبنان ، اتفق على إصدار مبادئ عامة، تضمنها بيان رئيس الجمهورية، في 14 فبراير 1976. ومن بين التغييرات المهمة: تأكيد البيان على انتماء لبنان العربي، والأخذ بمبدأ المناصفة في عدد المقاعد، المخصصة للمسلمين والمسيحيين، واختيار رئيس الوزراء بواسطة المجلس، بدلاً من انفراد رئيس الجمهورية بتكليف من يشغل هذا المنصب. وبالنسبة إلى وضع الفلسطينيين، أكد البيان احترام اتفاقية القاهرة عام 1969. كما أُعلن إلغاء الطائفية في الوظائف، ولكنه أبقى عليها، بالنسبة إلى الوظائف الثلاث الكبرى، حيث نص على أن يكون رئيس الجمهوريـة مارونياً، ورئيس الوزراء مسلمـاً سنيـاً، ورئيس مجلس النـواب مسلمـاً شيعياً ، اتفق على إصدار مبادئ عامة، تضمنها بيان رئيس الجمهورية، في 14 فبراير 1976. ومن بين التغييرات المهمة: تأكيد البيان على انتماء لبنان العربي، والأخذ بمبدأ المناصفة في عدد المقاعد، المخصصة للمسلمين والمسيحيين، واختيار رئيس الوزراء بواسطة المجلس، بدلاً من انفراد رئيس الجمهورية بتكليف من يشغل هذا المنصب. وبالنسبة إلى وضع الفلسطينيين، أكد البيان احترام اتفاقية القاهرة عام 1969. كما أُعلن إلغاء الطائفية في الوظائف، ولكنه أبقى عليها، بالنسبة إلى الوظائف الثلاث الكبرى، حيث نص على أن يكون رئيس الجمهوريـة مارونياً، ورئيس الوزراء مسلمـاً سنيـاً، ورئيس مجلس النـواب مسلمـاً شيعياً . .
ومن الواضح، أن موافقة الحكومة اللبنانية على مهام اللجنة الثلاثية، المشار إليها، ثم التخلي عن بعض امتيازات الموارنة، حسب برنامج الإصلاح المعلن، يدلان على أن الموارنة، قد اضطروا، للمرة الأولى، منذ الميثاق الوطني في عام 1943، إلى التراجع عن تصلبهم التقليدي في عدة أمور. ومع ذلك، فإن البرنامج الإصلاحي، شأنه في ذلك شأن الحلول التقدمية التوفيقية، لم يكن في وسعه أن يرضي جميع الأطراف. فالجبهة التقدمية، بزعامة جنبلاط، اعترضت على التوزيع الطائفي، أصلاً، وطالبت بإلغائه، على جميع المسـتويات. كما أن معظم بطاركة الموارنة، أبدوا استياءهم من هذا البرنامج. ولم يمض زمن طويل على إعلانه، حتى تفاقمت الأزمة، وشهد لبنان ظاهرة تنذر بالخطر، لم يمر بمثلها أثناء أزمة عام 1958. فقد امتد الصراع إلى صفوف الجيش، فخرج بعض المسلمين على القيادة، بزعامة ملازم أول، يُدعى أحمد الخطيب. وكون المنشقون ما سمي بـ "جيش لبنان العربي". في حين أنشأ أنصار سليمان فرنجية "جيش التحرير الزغرتاوي"، بقيادة توني فرنجية، ابن رئيس الجمهورية. وتصاعد شأن الخطيب في إقليم البقاع.
وتأكدت عوامل انهيار الدولة حينما شن رشيد كرامي حملة على رئاسة الجمهورية، وقيادة الجيش، التي تغمض العين عن تهريب الأسلحة إلى "الكتائب" والميليشيات المارونية.
وبينما كان الجدل دائراً بين كرامي وفرنجية، قام عزيز الأحدب، قائد حامية بيروت، بمحاولة شخصية، لوضع حد لهذه الفوضى. فأصدر بياناً، في 11 مارس 1976، يدعو فيه كلا من رئيسي الجمهورية والوزارة، إلى الاستقالة، وأن يختار مجلس النواب رئيساً جديداً في غضون سبعة أيام.
اعتبر فرنجية هذا العمل انتهاكا للشرعية وللديموقراطية. في حين نفى الأحدب، أن تكون لحركته صفة الانقلاب العسكري، مؤكداً أن الهدف منها، هو إنقاذ البلاد من الفوضى . والواقع، أن هدف الأحدب، لا يتخطى هذا القصد. فحركته تختلف عن حركة أحمد الخطيب، الذي كان يسـعى إلى إدخال تغييرات جذرية في أوضاع لبنان. ولا شك أن مركز فرنجية، صار مزعزعاً بعد تفكك الجيش. ولذلك، أبدى استعدادا للاستقالة، إذا طلب ذلك ثلثا أعضاء المجلس. فلما تحقق هذا الشرط، ووقع 68 نائباً طلباً باستقالة رئيس الجمهورية، عاد فرنجية يحتج بأن الدستور لا يلزمه بالاستقالة، إلا في حالة الخيانة العظمى. هذا، مع العلم بأن مدة رئاسته، كانت موشكة على نهايتها، فلم يبق منها سوى ستة أشـهر. ومما شجعه على التمسك بالرئاسة، ظهور رد فعل ماروني في الجيش. فقد ظهر العقيد أنطوان بركات، ليعلن أنه سيكرس جهوده للدفاع عن الشرعية، ويعني بذلك شخص فرنجية. . والواقع، أن هدف الأحدب، لا يتخطى هذا القصد. فحركته تختلف عن حركة أحمد الخطيب، الذي كان يسـعى إلى إدخال تغييرات جذرية في أوضاع لبنان. ولا شك أن مركز فرنجية، صار مزعزعاً بعد تفكك الجيش. ولذلك، أبدى استعدادا للاستقالة، إذا طلب ذلك ثلثا أعضاء المجلس. فلما تحقق هذا الشرط، ووقع 68 نائباً طلباً باستقالة رئيس الجمهورية، عاد فرنجية يحتج بأن الدستور لا يلزمه بالاستقالة، إلا في حالة الخيانة العظمى. هذا، مع العلم بأن مدة رئاسته، كانت موشكة على نهايتها، فلم يبق منها سوى ستة أشـهر. ومما شجعه على التمسك بالرئاسة، ظهور رد فعل ماروني في الجيش. فقد ظهر العقيد أنطوان بركات، ليعلن أنه سيكرس جهوده للدفاع عن الشرعية، ويعني بذلك شخص فرنجية.
ومجمل القول أن الجيش، الذي كان عاملاً مخففاً لأزمة عام 1958، صار في أزمة 1975 ـ 1976، طرفاً مشتركاً فيها. فتفرقت وحداته، وانضمت إلى الميليشيات المتصارعة، حسب انتماءاتها الطائفية. وأدى ذلك إلى توسيع نطاق القتال، فبلغ من الضراوة، خلال النصف الثاني من شـهر مارس 1976، ما لم يشهده لبنان من قبل. ولوحظت حركة هجرة جماعية، يقوم بها المسيحيون إلى خارج البلاد، مما يعني أن كفة الجبهة التقدمية اللبنانية، المشتركة مع الفلسطينيين، قد رجحت على العناصر الأخرى. وهنا، جاء التدخل السوري ليقلب ميزان القوى.
بدا التدخل السوري، في أول الأمر، وكأنه وساطة، تستهدف الدفاع عن المطالب العادلة للمسلمين ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك طبقاً لمواقف سورية التقليدية من أزمات لبنان. بيد أن تحولاً في الموقف السوري، أخذ يظهر للعيان، بالتدريج، منذ مارس 1976. ففـي بيان رسمي، في31 مارس، نددت حـكومة دمشق باليسار اللبناني، الذي يتشدد في شـروطه لإعادة وقف إطلاق النار . وكان البيان يُلمح، بصفة خاصة، إلى موقف كمال جنبلاط، الذي اشترط استقالة رئيس الجمهورية، قبل الاشتراك في أي محادثات، تستهدف وقف إطـلاق النار. وما لبثت سورية أن تجاوزت البيانات الرسمية، إلى المواجهة العسكرية ضد اليسار اللبناني. ثم دخلت في صراع دامٍ مع المنظمات الفلسطينية. . وكان البيان يُلمح، بصفة خاصة، إلى موقف كمال جنبلاط، الذي اشترط استقالة رئيس الجمهورية، قبل الاشتراك في أي محادثات، تستهدف وقف إطـلاق النار. وما لبثت سورية أن تجاوزت البيانات الرسمية، إلى المواجهة العسكرية ضد اليسار اللبناني. ثم دخلت في صراع دامٍ مع المنظمات الفلسطينية.
إن أقوى المبررات، التي قدمتها الحكومة السورية لهذا التحول، هو أنه إذا ما انهارت السلطة في لبنان، ووجدت إسرائيل أن الجبهة التقدمية اللبنانية الفلسطينية، تملأ هذا الفراغ فلا بد أن تقوم بعدوان، لاحتلال جزء من لبنان. فمن الأفضل المحافظة على النظام، حتى تفوت على إسرائيل مثل هذه الفرصة. بيد أن هذا التبرير، لا ينفي وجود عوامل أخرى، دفعت سورية إلى هذا التحول، من بينها الرغبة في السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، وقد استخدمت لهذا الغرض عناصر "الصاعقة" الفلسطينية، التي تدين بالولاء لحكومة دمشق. ومن بين هذه الأسباب تأثر الصراع اللبناني بالمنافسات العربية. فهناك فئات ترتبط بالبعث العراقي، وفئات أخرى تتطلع إلى مصر. ولما كانت علاقة سورية بهذين القطرين متوترة، في ذلك الوقت، فقد رأت أن تسبق إلى التدخل، حتى تنفرد بمعالجة الأزمة اللبنانية. ومن جهة أخرى، فإن تحول الموقف السوري، قد أزال اعتراضاً أمريكياً محتملاً، ظهر في بداية الحرب الأهلية. أمّا بعد أن تكشف هذا التحول، فقد أعلنت الحكومة الأمريكية، أن الوساطة السورية عنصر إيجابي في أزمة لبنان.
دخلت القوات السورية منطقة البقاع على صورة تسلل. وفي أبريل 1976، أعلن حافظ الأسد، أن سورية ستتدخل لحماية المظلومين، أياً كانوا، وقد يكون المظلومون، في رأيه، هم "الكتائب" وحلفائهم. وعلى أي حال، فقد تحول لبنان إلى سـاحة، تتصارع فيها القوى الداخـلية والخارجـية. ومما يدل على ذلك، توقيع اتفاق في 18 أبريل من العام نفسه، بين سورية ومنظمة التحرير، تسـتهدف تدعيم وقف إطلاق النار . ويُظهر لنا هذا الاتفاق، كيف أن سورية غدت تمثل الطرف، الذي يتحدث باسم اليمين اللبناني، بينما تقف منظمة التحرير كنائب عن اليسار. . ويُظهر لنا هذا الاتفاق، كيف أن سورية غدت تمثل الطرف، الذي يتحدث باسم اليمين اللبناني، بينما تقف منظمة التحرير كنائب عن اليسار.
ومنذ اشتداد القتال، تردد الحديث عن "تدويل المسألة اللبنانية، أو تعريبها"، أي إرسال قوات دولية، أو عربية، للفصل بين المتنازعين. وأبدى معظم الفئات اللبنانية اعتراضاً على كلا الحلين. إلا أنه بعد أن ظهر انحياز القوة العسكرية السورية، ومعها منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، إلى جانب اليمين، عاد كمال جنبلاط، زعيم اليسار، يؤيد تدخل قوات عربية، في إطار الجامعة العربية. وبذا، اتفقت وجهة نظره مع وجهة نظر الحكومة المصرية.
اتسع انتشار القوات السورية، خلال شهر يونيه 1976، وظهرت على الساحل، وحول بيروت. واكتسبت سورية نفوذاً سياسياً بانتخاب "إلياس سركيس" رئيساً للجمهورية، وهو أكثر تقبلاً للتعاون مع حكومة دمشق. وانعكست آثار هذا التدخل، بصورة سيئة، على المقاومة الفلسطينية، إذ شرعت منظمة "الصاعقة" تصادم اليسار اللبناني في طرابلس، وهو يمثل إحدى الفئات المتمتعة بتأييـد البعث العراقي. ولم تستمع "الصاعقة" لنداء ياسر عرفات، بالتوقف عن هذه المعارك الجانبية. وبذا، تأكدت الانقسامات في حركة المقاومة الفلسطينية، نتيجة للتدخل السوري.
أخذت الهوة تتسع، من جهة أخرى، بين منظمة التحرير الفلسطينية والقوات السورية، التي ارتبطت مع العناصر اليمينية. وبلغ الصراع ذروته بمذبحة مخيم "جسر الباشا"، في 29يونيه1976، ومذبحة "تل الزعتر"، في 12 أغسطس 1976، وهو من أكبر المعسكرات الفلسطينية في لبنان، وعادت ذكريات "أيلول الأسود" الأردني، تمثل في الأذهان، باسم "تموز الأسود في لبنان" . .
حارت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بين التقارب من مصر، والعودة إلى توثيق علاقاتها بسورية. ومن الواضح، أن الظروف السائدة ـ آنذاك ـ هي التي جعلت سورية مسيطرة على لبنان، المعقل الأخير للمقاومة. فاضطرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الانحناء أمام العاصفة. والخلاصة هي أن المقاومة الفلسـطينية، التي كانت، في البداية، إحدى عوامل الإثارة للحرب الأهلية اللبنانية، صارت من أشد ضحاياها تضرراً منها. وإزاء هذه المحاور، التي امتدت للحرب الأهلية اللبنانية، تجددت فكرة إشراك دول عربية أخرى، سواء في إطار الجامعة، أو خارجها، للمساعدة على الخـروج من هذه الأزمـة. وانعقد، بناءاً على هذه الفكرة، مؤتمر قمة محدود، في الرياض، الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 1976 . وحـاول المؤتمرون، أن يعطـوا الوجود العسكري السوري صفة عربية، وذلك بإشراك قوات من دول أخرى، "محايدة"، كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسودان. وتسمية هذه القوات بـ "قوات الردع العربية"، على أن يتحمل بعض دول النفط نصيباً من نفقاتها. . وحـاول المؤتمرون، أن يعطـوا الوجود العسكري السوري صفة عربية، وذلك بإشراك قوات من دول أخرى، "محايدة"، كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسودان. وتسمية هذه القوات بـ "قوات الردع العربية"، على أن يتحمل بعض دول النفط نصيباً من نفقاتها.
وعُدّت القرارات الصادرة عن قمة الرياض كسباً لسياسة سورية. فقد أصبحت قواتها موجودة في لبنان، بتأييد من أطراف عربية كثيرة، ومن بينها مصر، التي اشتركت في مؤتمر الرياض، فضلاً عن أنها خففت عن سورية قدراً من الأعباء المالية، اللازمة لنفقات هذه القوات.
نتائج حرب السنتَيْن (1975 ـ 1976)
كان للحرب الأهلية اللبنانية انعكاسات بعيدة المدى، على القضية الفلسطينية، وإلى درجة أقل على العلاقات العربية. ويمكن حصر نتائج تلك الحرب، بالنسبة إلى لبنان، في الأمور التالية:
|
1.
|
تمزق لبنـان، واقعياً، إلى مناطق شبه مستقلة، لها إدارتها المدنية الخاصة، ومنظماتها العسكرية، التي تدافع عنها. وبدت خريطة لبنان، في بعض الوقت، وكأنها موزعة بين ثلاث إدارات:
|
أ.
|
السـاحل، ابتداء من جنوب بيروت وحتى الحدود الإسرائيلية، ويخضع لإدارة الجبهة التقدمية (القوى اليسارية اللبنانية)، المشتركة مع الفلسطينيين.
|
|
ب.
|
القسـم الساحلي الشمالي، ما بين بيروت وطرابلس، إضافة إلى معظم أجزاء الجبل، ويخضع لإدارة مسيحية (القوى اليمينية اللبنانية).
|
|
ج.
|
الباقي من لبنـان وتقدر بنحو 60% من مساحة البلاد، ويخضع لإشراف سوري.
ومما هو جدير بالذكر، أن سورية امتنعت عن إرسال قواتها إلى الجنوب، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية، التي ذكرت أن هناك خطاً معيناً، إذا تجاوزته القوات السورية، فإن لإسرائيل، حينئذ، حرية التصـرف في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وعندما عقد اتفاق شتوره، في يوليه1977، بين سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية وممثلين عن لبنان، بقصد سحب القوات الفلسطينية من الجنوب، تعذر تنفيذ الاتفاق، لأن العناصر اليمينية في المنطقة، لم تسـتجب لقرارات شتورا، التي تقضي، أيضاً، بدخول الجيش اللبناني للمحافظة على الأمن في الجنوب. وفضلت هذه العناصر الاعتماد على مؤازرة إسرائيل بصورة مكشوفة، حتى ليمكن القول إن من ذيول الحرب الأهلية، تسلل النفوذ الإسرائيلي، بشكل غير مباشر، إلى جنوب لبنان.
|
|
|
2.
|
انتهاء عهد طويل من تمتع الموارنة بمميزات عدة في البلاد. ولا أدل على تراجع نفوذهم، من تقبلهم وجود قوات عسكرية سورية على أرض لبنان، حتى لو كانت تستهدف الدفاع عنهم. ذلك أن وجود قوات سورية، أو عربية، على أرض لبنان، كان ينظر إليه ـ من قبل ـ كتهديد للكيان اللبناني.
|
|
3.
|
تخريب الاقتصاد اللبناني تخريباً، يجعل إصلاحه أمراً صعباً، ويحتاج إلى وقت طويل. ذلك لأن التخريب، لم يقتصر على هدم المنشآت والمصارف وغير ذلك من المؤسسات التجارية، بل إن الحرب الأهلية، دفعت كثيرين من أصحاب الخبرة إلى مغادرة البـلاد، وكذلك الرأسماليون الذين هَربوا ثرواتهم إلى الخـارج. أي أن لبنان افتقد العنصرين، اللذين يمكنهما إعادة البنـاء. وقُدرت الخسائر بسبب أضرار الحرب، عام 1976، بما يقارب المليارين ونصف المليار من الدولارات، وفقد لبنان الأمن وكل مقومات النشاط الاقتصادي الفعال. كما فقد مكانته، كمركز مالي، إذ أغلقت المصارف الأجنبية أبوابها ورحلت. كما فقد مكانته، كمركز تجاري ومنطقة جذب سياحي.
وبسبب انعدام الأمان، فضلاً عن أن دول المنطقة بدأت تتكيف مع غياب الدور الإقليمي للاقتصاد اللبناني، بدأت تظهر مراكز مالية وتجارية جديدة، في دبي والبحرين ومصر. وتطورت العلاقات التجارية المباشرة، بين الدول العربية والمراكز التجارية المهمة في العالم، من دون الحاجة إلى وسـاطة التجار اللبنانيين. كما بدأت سياسات تحرير الاقتصاد، تزحف على اقتصاديات دول المنطقة، حتى أصبحت سمة عامة لها، ففقد الاقتصاد اللبناني ككل ميزة نسبية في هذا الصدد. كما تطور العديد من المراكز السياحية في المنطقة، في ظل غياب لبنان عن المسرح السياحي.
ـــــــــــــ
|
|