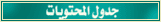




|
ثالثاً: الأسباب الاقتصادية منذ مطلع الثمانينات، أخذت السّياسة السّكانية الإسرائيلية أبعاداً خطيرة، تجاه الجانب العربي الفلسطيني، انطلاقاً من أن العنصر البشري هو أحد العناصر الضامنة لبقاء النموذج الصهيوني، الذي تمثله إسرائيل، في إطار المجتمعات الاستيطانية عموماً. وقد تجسدت السّياسة الإسرائيلية، اقتصادياً، في إجراءات الإبعاد والتهجير والتضييق الاقتصادي والتوسع الاستيطاني، وتشجيع التكاثر في المجتمع اليهودي. وأبرزت الفترة، التي سبقت اندلاع الانتفاضة، المساوئ الاقتصادية للاحتلال، على نحو خطير. فقد تضرر القطاع الزراعي كثيراً، بفعل أكثر من عامل، أهمها توسيع حركة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، والتحايل بالتزوير للاستيلاء عليها. وقد أدت حالة الدّمج الاقتصادي للضفة وغزة، في الاقتصاد الإسرائيلي، إلى تهميش الحضور الوطني الفلسطيني، مما أسهم في استفزاز المشاعر الوطنية الفلسطينية، حيث شعروا أن قوتهم وحياتهم اليومية، متوقفان على الاقتصاد الإسرائيلي. وساد نمط من التبادل غير المتكافئ بين الاقتصاديين، لصالح الاقتصاد الإسرائيلي. ويُعد استغلال الاحتلال للضفة والقطاع، وجعلهما كمصدرين لليد العاملة الرخيصة، ولبعض المواد الخام، وللقليل من الصناعات البسيطة الضرورية للصناعة الإسرائيلية، نموذجاً للتبعية والامتهان للاقتصاد الفلسطيني. لم يهتم الاحتلال، في هذا السّياق، بالبنية التحتية لاقتصاد المنطقتين المحتلتين (خطوط المواصلات، وشبكات الكهرباء، والمياه، والهاتف، والبريد) وتآكلت خطوط المواصلات، واحتكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية إمداد المناطق المحتلة بالكهرباء، بما فيها القدس. وقد عانت تجارة الضفة والقطاع مع إسرائيل، من عجز كبير لصالح إسرائيل. فبعد أن وصل في عام 1968م إلى 38 مليون دولار، ارتفع إلى 430 مليون دولار عام 1984م، وشكّلت واردات الضفة والقطاع من إسرائيل، حوالي 90% من مجمل وارداتها، فيما استطاعت صادرات الضفة والقطاع إلى إسرائيل، أن تشكل 80% من مجموع صادرات القطاع، و60% من مجموع صادرات الضفة، و90%، منها منتجات صناعية. وقد عانت الزراعة الفلسطينية، أكثر من غيرها، في مرحلة ما قبل الانتفاضة، بسبب التوسع في مصادرة الأراضي، وحبس المياه، ومنافسة المحاصيل الإسرائيلية المدعومة. ووضع الإسرائيليون عراقيل إدارية متعددة، أمام المزارعين العرب. وتردت الخدمات الزراعية، وفرض نظام حصص جائر، بهدف تدمير البنية المحصولية، وتم حظر تسويق المنتجات الزراعية في السوق الإسرائيلية، إضافة إلى تعطيل تصدير المنتجات إلى الخارج، وقلل ذلك من فرص العمل بالقطاع الزراعي. على المستوى الصناعي، شكلت الصناعة، عندما احتُلت الأراضي العربية نحو 6,6% من إجمالي الناتج المحلي للضفة، مقابل 3,3% في قطاع غزة، وغلب، على القطاع الصناعي، الطابع الحرفي. وقد أبقى الاحتلال الإسرائيلي على هذا الوضع، مما حال دون إقامة صناعات جديدة. وضاعف القيود على استيراد المواد الخام لهذه الصناعات، وعطل تصدير السلع المصنعة، وحرم الصناعة من التسهيلات الائتمانية، فضلاً عن التأثير الضار لإهمال الاحتلال شؤون البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني. وتتضح الفجوة، بين الصناعة الإسرائيلية، ومثيلتها في الضفة والقطاع، من أن الثانية تمثل 1.7% فقط من إجمالي الناتج الصناعي الإسرائيلي عام 1984م. وقد تجلى تهميش اقتصاد الضفة والقطاع في ظاهرة فائض اليد العاملة، حيث هاجر ما يزيد عن 350 ألف مواطن، من الضفة وغزة، خلال الفترة من 1967م إلى 1984م، إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل. كما أن 130 ألفاً آخرين اضطروا للعمل في مجالات شاقة داخل إسرائيل، مقابل أجور زهيدة، تصل إلى نصف ما يتقاضاه العامل الإسرائيلي. وتذكر الإحصائيات أن إسرائيل كانت توفر سنوياً، من فروق الأجور، ما يقرب من 300 مليون دولار، منذ عام 1985م، بجانب 100 مليون دولار، هي قيمة مستحقات عمال الضفة وغزة، لدى صندوق التأمين الإسرائيلي. وفي دراسة أجرتها جامعة هارفارد، ومولتها مؤسستا فورد وركفلر، على سكان غزة والضفة، تبين أن سكان القطاع، هم أفقر مَنْ يعيشون بالمناطق المحتلة، حيث يعيش فيها 38% من الفلسطينيين، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه مساحتها 140 ميلاً مربعاً. وأوضحت الدراسة أنه، على الرغم من ارتفاع الدخل الفردي، فإن الأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر؛ نظراً لانخفاض الإنتاج الاقتصادي من الموالح، من243 ألف طن عام 1975، إلى 164 ألف طن عام 1984. وهكذا، فإن هذه الأسباب: الاجتماعية النفسية، والسياسية، والاقتصادية، هي الدافع والمحرك الأساسي لاشتعال الانتفاضة. وعلى الرغم من ذلك فهناك أسباب، أو دواعٍ أخرى، أهمها: 1. الدواعي الدينية تخضع طبيعة الصراع بين اليهود والفلسطينيين، إلى عامل الدين والمعتقد والتاريخ، حيث يؤمن كل طرف بعداوة الطرف الآخر، دينياً، كما يؤمن بحتمية الصراع معه، والتخلص منه، ولو بعد حين. بسبب كثرة عدد المسلمين، وتفوقهم على اليهود بأضعاف كثيرة، عَمِل اليهود، طيلة فترات حكمهم السابقة، على عدم إثارة الجانب الديني، وعدم إعلان الحرب تحت راية دينية مكشوفة، خوفاً من اجتماع المسلمين عليهم تحت راية الإسلام، فتكون الهزيمة المحتمة. ومن هنا كانت الدواعي الدينية، من أهم عوامل استمرار الصراع وتأجيج الانتفاضة. ويندرج تحت هذا البند عدة نقاط، تشكل كل منها داعياً، أدى بشكل غير مباشر إلى الانتفاضة الكبرى، في 9 ديسمبر 1987. |